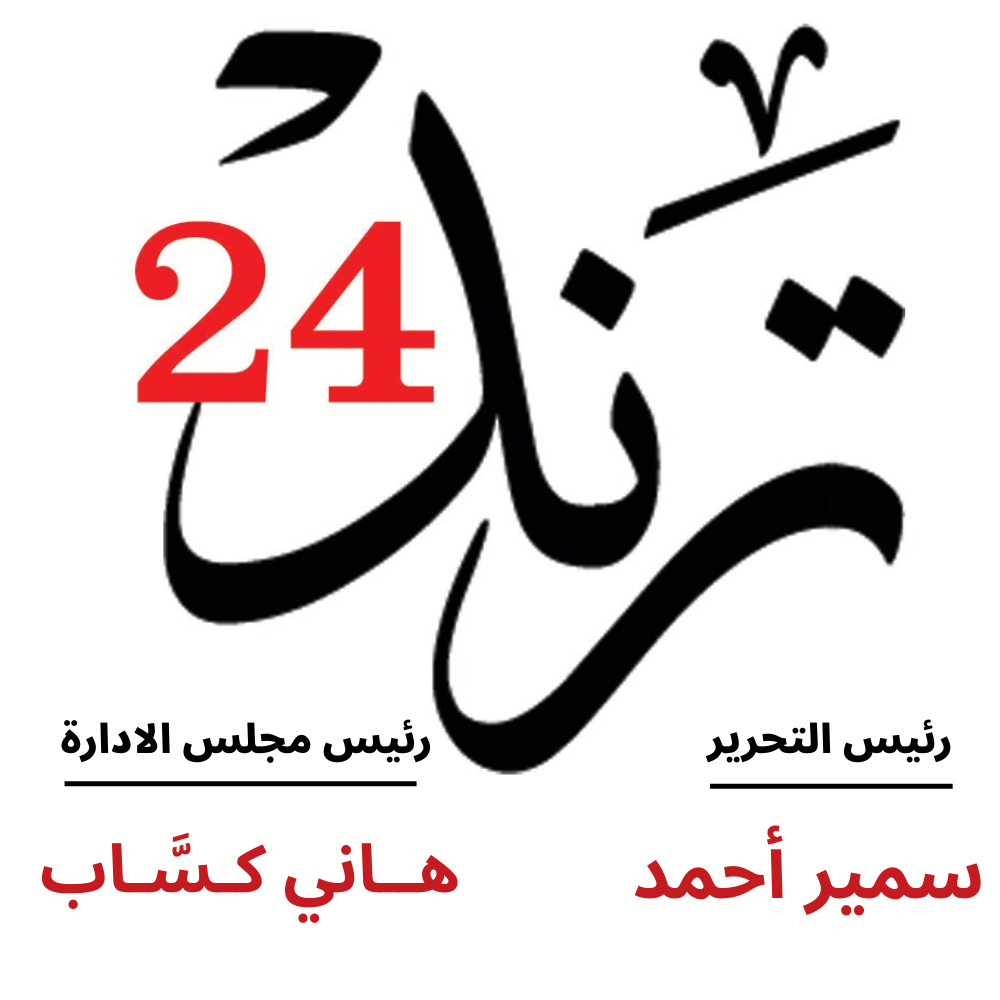“ربع ولاد جساس”… دراما الغجر بين حكمة الماضي وصراعات الحاضر.

بقلم : يوسف إبراهيم
في الليلة الثامنة من المهرجان الإقليمي لفرق الأقاليم – إقليم شرق الدلتا الثقافي، وعلى خشبة قصر ثقافة الزقازيق، قدّمت فرقة فلاحين المنصورة عرضها المسرحي “رَبع ولاد جساس”، تأليف عبده الحسيني، وإخراج علاء نصر، في تجربة مسرحية تحمل خصوصية مكانية واجتماعية نادرة، وتغوص في عمق بيئة شديدة الهامشية: عالم الغجر.
وهي محاولة درامية للغوص في عالم الغجر، بكل ما فيه من خصوصية اجتماعية وثقافية، داخل ربعٍ يتصارع فيه الأفراد على القيادة، بينما تتقاذفهم الأمواج النفسية والاجتماعية في ظل غياب “حكيم الربع”.
ما الذي يجعل عالم الغجر موضوعًا مغريًا دراميًا؟ أهو الغموض؟ الطقوس؟ الترحال؟ أم هي تلك المسافة الممتدة بين الغجر كحقيقة اجتماعية، وبينهم كصورة ذهنية مشوّهة في الوعي الشعبي؟
ربما يكمن سحر العرض في قراره الخوض في هذا العالم من زاوية نادرة: من داخل الغجر أنفسهم، لا من أعين من يراقبهم من الخارج.
في حضرة الغجر… حين يغيب الحكيم ويتكلم الربع
ليست كل المسارح تصنع عالمًا، لكن حين تفتح الستارة على “ربع ولاد جساس”، تشعر أنك لم تدخل عرضًا مسرحيًا… بل عبرت إلى عالم موازٍ، تُساق فيه الحكمة بالعصا لا بالكلمة، وتُوزن فيه الكرامة على دفوف الغجر.
في عالمٍ مهمَّشٍ كالغجر، لا تُكتب القوانين على ورق، بل تُحفر في العيون، وتُورَّث في الجينات، ويصير غياب “الحكيم” كأنما انفراط عِقدٍ من الذاكرة.
كل حجر في الربع يئنّ، وكل وشمٍ على ذراعٍ يحكي، وكل دفٍّ صامت كأنّه فقد صوته في ضجيج الصراع.
“رَبع ولاد جساس” ليس مجرد اسم لحيّ أو عائلة. إنه وطن صغير منسيّ داخل الوطن الكبير. وطن تتصارع فيه الرؤى لا على السلطة فحسب، بل على من يستحق أن يكون رمزًا… من يصلح أن يكون صوت الوجدان لا صدى العصبية.
في هذا الربع، الحكمة ليست رتبة… بل اختبار.
فحين يغيب من يُحسن الربط بين القلوب، تتنازعها الأهواء، وتصبح الدماء أقرب من الكلمات، والدفوف تُقرع للحرب لا للفرح.
لكن المسرح، مثل الحكيم الغائب، يعود ليقول كلمته:
ثمة شيء نقيّ دائمًا يمكن استعادته… فقط حين نكف عن النظر من علٍ، ونتعلّم أن نسمع صوت الذين يعيشون تحت السقف المائل… أولئك الذين يسمّونهم “غجر”.
عنوان المسرحية “رَبع ولاد جساس” ليس مجرد دلالة مكانية، بل إعلان عن هوية جمعية، وانتماء دموي ووجداني لكيان مهدد بالصراع والانقسام بعد غياب رمزه الأسمى: حكيم الربع.
ينطلق النص من غياب “الحكيم الأكبر”، الرجل الذي يمثّل الحكمة والتوازن داخل هذا المجتمع الغجري الصغير. هذا الغياب يفتح الباب لصراع بين أفراد العائلة حول من الأحق بأن يتصدر المشهد ويقود “الربع”.
الدراما لا تقتصر على الصراع حول الزعامة، بل تتشابك مع العلاقات الإنسانية، والعادات الغجرية، وأوجه التباين بين من يسعون للحفاظ على الهوية، ومن يسقطون في فخ الأنانية والطمع.
ومع تصاعد الأحداث، يعود الحكيم في لحظة ذروة ليعيد ترتيب الفوضى، ويُرمم العلاقات التي تفتّتت، وكأن العرض يريد أن يقول: الحكمة الغائبة هي مفتاح التوازن في المجتمعات الصغيرة.
عبده الحسيني يكتب نصًا ينبض بالدراما الشعبية، متكئًا على موروثات الشرف والدم والانتماء، ويمزج بين الواقعية والأسطورة، ليخلق عالما حيًّا، فيه التقاليد الغجرية، والصراعات الإنسانية، والمواقف التي تمتح من الحياة اليومية رغم خصوصية البيئة.
لكن الأهم، أن النص لا يقدّم الغجر ككائنات غرائبية، بل كبشر يُخطئون ويصيبون، ويتصارعون ويحنّون، ويحتاجون دائمًا إلى من يُذكّرهم بأن الحكمة لا تورّث، بل تُكتسب وتُستحق.
المخرج علاء نصر اختار مقاربة إخراجية تميل إلى البساطة التعبيرية أكثر من التجريب الجمالي، معتمدًا على ثبات المشهد المكاني (الديكور) الذي يمثّل “الربع” بكل تفاصيله الترابية والبسيطة.
العرض تحرّك داخل إطار مغلق لكنه غني بالتحولات النفسية، حيث استُثمرت بعض الزوايا الركحية لإبراز التحالفات والانشقاقات داخل العائلة الغجرية، مع توظيف فعّال للإضاءة لإبراز حالات الصراع أو لحظات الحسم الدرامي.
إلا أن العرض افتقر إلى حيوية المشهد الغجري المتوقعة؛ فالغجر كما نعرفهم يميلون إلى الاستعراض والغناء والحركة، وقد بدا غريبًا أن تغيب اللوحات الاستعراضية تقريبًا عن عرض يقدمه فريق فني أساسه “فرقة الفنون الشعبية”باستثناء “الأوفرتير” الذي قدّم مشهدًا غجريًا بالدفوف والإيقاعات ، وكان من الممكن أن تُستثمر هذه القدرات لتقديم حالة فنية أشمل تُضيف للعرض بعدًا بصريًا واحتفاليًا يعكس روح الغجر وحياتهم الصاخبة. غياب هذا الجانب يُعدّ فرصة فنية ضائعة، كان من شأنها أن ترفع من إيقاع العرض وتثري تجربته.
شهد العرض تباينًا واضحًا في أداء الممثلين. بعض الشخصيات قدّمت أداءً صادقًا متماهيًا مع البيئة والموقف، بينما بدا البعض الآخر مرتبكًا في حركته ونطقه وانفعاله، وكأن خشبة المسرح لم تكن بعد أرضًا مألوفة لأقدامهم.
أداء الشخصيات المركزية التي تمحورت حولها الصراعات كان أفضل نسبيًا من الشخصيات الثانوية، ما يشير إلى تفاوت في الخبرة والتدريب و مع ذلك، تُحسب للفريق محاولته خوض عالم درامي غير مألوف، والتعامل مع بيئة الغجر بطقوسها ولهجتها الخاصة، وهو تحدٍ ليس سهلاً بأي حال.
جاءت الموسيقى في العرض بسيطة، واقتصرت على موسيقى تصويرية مصاحبة للمشاهد، دون توظيف حيّ أو مباشر على خشبة المسرح. وعلى الرغم من محدودية التوظيف، فإن الموسيقى نجحت أحيانًا في خلق أجواء مشحونة بالعاطفة والغموض.
أما الديكور، فكان ثابتًا وبسيطًا، لكنه عبّر بصدق عن طبيعة “الربع” كمكان مشترك بين الغجر، حيث الحياة القبلية والمجتمعية تحت مظلة واحدة.
صوت الغجر بين التهميش والاعتراف
العبارة الترويجية للعرض: “دعوة للاستمتاع بحياة الغجر كما لم ترها من قبل”، تكشف النية الواضحة لصناع العرض: تقديم الغجر بصورة منصفة، إنسانية، بعيدة عن الابتذال أو الوصم الشعبي.
وقد نجح النص – رغم التفاوت في الأداء – في نقل هذه الصورة بشكل نسبي، من خلال تسليط الضوء على قيم الغجر في العائلة، والانتماء، والشرف، والولاء، وكذلك في التأكيد على أن كل صراع، مهما تعقّد، لا بد له من حكمة تعيد الأمور إلى نصابها.
ختاماً ، “ربع ولاد جساس” عرض يحمل نية درامية نبيلة في تقديم صورة غير نمطية لعالم الغجر، ومحاولة لتسليط الضوء على صراعات الهوية والقيادة داخل مجتمعاتهم.
ورغم الملاحظات المتعلقة بالأداء والتوظيف البصري، فإن النص والجهد المبذول يستحق التقدير، ويُمهد الطريق لتطوير هذا النوع من العروض التي تمزج بين الدراما الشعبية والتاريخية في فضاء مصري أصيل.
“رَبع ولاد جساس” ليس مجرد عرض عن الغجر، بل هو مرآة لصراعات أي مجتمع في لحظة غياب الحكمة، وحين تُصبح القيادة مطمعًا لا مسؤولية، فتنفجر الأحقاد، وتضيع البوصلة… حتى يعود من يُجيد الإمساك بها.